يشعر كثيرٌ من المسلمين اليوم في بعض بلدان العالم الإسلاميِّ بغربة شديدة؛ ذلك أن هذه البلدانَ يغيب فيها حكمُ الله، ولا يحتكمُ الناسُ فيها في محاكمهم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ بل تعتمد تلك المحاكمُ القوانينَ الأوربية، فلا تُقام فيها الحدود، ولا يؤمَر فيها بالمعروف ولا يُنهى عن المنكر.
وتراهم يُعلنون الشعارات الجاهلية من قوميةٍ، واشتراكيةٍ، ونحو ذلك.
وقد توقَّع هذه الغربةَ بعضُ الناس بالحسرة والحزن، واليأس والإحباط؛ ولكن ينبغي للغرباء أن يسعَدوا بقول رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في الحديث الصحيح: ((فطُوبى للغُرَباء)).
طوبى لهم؛ لأنهم ثبَتوا على الحقِّ حين انحرف كثيرٌ من الناس إلى الباطل.
طوبى لهم؛ لأنهم استقاموا على الطريقة القويمة، فقاموا بما أمرَ الله به، وانتهَوا عمَّا نهى الله عنه.
طوبى لهم؛ لأنهم لم يُبالوا بالأعراف الدَّخيلة عليهم؛ بل انطَلقوا في هذه الحياة يتعَلَّمون دينَ الله ويُعلِّمونه، ويَدْعون إلى الله ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً.
قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((بدأ الإسلامُ غرِيبًا، وسيعودُ كما بدأ، فطُوبى للغُرَباء)).
نعم، بدأ الإسلام غريبًا.. لقد واجه الإسلام العالَمَ وهو يقوم على ظُلم الإنسان لأخيه الإنسان، وتسودُه الجهالة الجهلاء، ظلماتٌ بعضها فوق بعض، وتصوِّرُه كلمة جعفر بن أبي طالب – رضي الله عنه – للنجاشيِّ ملك الحبشَة، إذ قال: “أيها الملك، كنَّا قومًا أهل جاهليَّة، نعبد الأصنام، ونأتي الفواحش، ونقطع الأرحام، ويأكل القويُّ منَّا الضعيفَ، فكنَّا كذلك حتى بعث الله فينا رسولاً منَّا”.
لقد كان الإسلامُ أمرًا غريبًا، أثار عجَبَ العرب الوثنيين؛ قال الله تعالى: ﴿ بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ * أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ ﴾ [ق: 2، 3]، وقال تعالى: ﴿ وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ * أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ﴾ [ص: 4، 5].
كان الإسلامُ غريبًا في نظَر المشركين الذين ذَكَرت الآياتُ الكريمة السابقة مَقُولتَهم.
ويبدو الإسلام غريبًا في نظر بعض الناس المعاصرين لنا من الأوربيين والأمريكيين، فلا يؤمنون بالعقيدة التي جاء بها؛ بل يُحاربونها ويُنْكِرُونها، إمَّا بالإلحاد، وإما بالتعصُّب الأعمى للباطل، ولا يرَوْن ما حرَّم الله حرامًا، ولا يَرَوْن ما أحلَّ الله حلالاً.
ويبدو أتْباعُ الإسلام الملتزمون به في نظرهم غرباء، غرباء في مجتمعاتهم، غرباء في مدارسهم – إن كانت لهم مدارس – غرباء في متاجرهم، غرباء في بُيُوتهم ومُثُلهم، وأخلاقهم وعاداتهم.
وهناك سؤال قد نُواجِهُه من قِبَل بعض الشباب، وهو:
ماذا ينبغي أن يكونَ موقفُنا نحن الغرباء؟
والجواب: إن عليهم أن يصبروا، ويتَّقوا الله، ويتوكَّلوا عليه، وأن يثبُتُوا على الحق، ويحرصوا على التميُّز عن أعداء الله، وأن يوقظوا في نفوسهم الشعورَ بالعزَّة التي كتَبَها الله لعبادِه المؤمنين؛ ﴿ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [المنافقون: 8]، وعليهم أن يستحضروا دائمًا قولَ الله عز وجل: ﴿ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ [آل عمران: 139].
وإن عليهم أيضًا أن يصبروا على ما يُصيبهم في أنفسهم وأموالهم؛ قال الله تبارك وتعالى: ﴿ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴾ [آل عمران: 186].
ذلك لأن الجزَع يقود إلى اليأس، وليس هناك مِعْوَل كاليأس يحطِّم النفس، ويُتيح للعدو الفرصة لكسب النصر في المعركة.
والرسولُ العظيم – صلى الله عليه وسلم – هو الأسوَةُ الحسنة للمؤمنين، فلقد كان المثلَ الأعلى في الصبر والمصابرة؛ فقد روى البخاريُّ في صحيحه عن عبدالله بن مسعود، أنه قال: كنَّا مع رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في المسجد وهو يصلي، فقال أبو جهل: ألا رجلٌ يقوم إلى فَرْثِ جَزُورِ بني فلان، فيُلقيه على محمد وهو ساجد، فقام عُقبَة بن أبي مُعَيط وجاء بذلك الفَرْث، فألقاه على النبي – صلى الله عليه وسلم – وهو ساجد، فلم يقدر أحدٌ من المسلمين الذين كانوا في المسجد على إلقائه عنه، فجاءت فاطمةُ فألقته عنه، فدعا عليهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم.
وقد صبر على مُقاطعة قريش له ولبني هاشم، هذه المقاطعة التي تعاهدَت عليها قريش، وكتبت في ذلك صحيفة وعلَّقُوها في الكعبة.
قال ابن إسحاق: “فلمَّا رأت قريش أن أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قد نزلوا بلدًا أصابوا به أمنًا وقرارًا، وأن النجاشيَّ قد منع مَن لجأ إليه منهم، وأن عمر قد أسلم فكان هو وحمزة مع رسول الله وأصحابه، وجعل الإسلام يفشو في القبائل – اجتمعوا وائتمروا بينهم أن يكتبوا كتابًا يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني المطلب، على ألا يُنكحوا إليهم أبدًا ولا ينكحوهم، ولا يبيعوهم شيئًا ولا أن يبتاعوا منهم، فلما اجتمعوا لذلك، كتبوه في صحيفة ثم تعاهدوا وتواثقوا على ذلك، ثم علقوا الصحيفةَ في جوف الكعبة؛ توكيدًا على أنفسهم”.
وقال ابن إسحاق: “فأقاموا على ذلك سنتين أو ثلاثًا حتى جهدوا، لا يصلُ إليهم شيء إلا سرًّا، مُستخفيًا به من أراد صلتَهُم من قريش”.
ثم قام خمسةٌ من أشراف قريش يطالبون بنقض هذه الصحيفة وشقُّوها، فخرج القوم إلى مساكنهم بعد هذه الشدَّة.
ولقد كان صبرُه – صلى الله عليه وسلم – مقرونًا بالأمل الواسع، ومن ذلك ما كان في يوم الأحزاب، يوم اجتمعَت هذه الأحزاب في غزوة الخندق على مُحاربة رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فواجهت الصحابةَ صخرةٌ غلظت عليهم، فأخذ المِعْوَلَ فضرب به ضربةً لمعت تحت المعول برقة، ثم ضرب به أخرى فلمعت تحت المعول برقة.
وكذلك كان في الضربة الثالثة، ثم تفتَّتَت الصخرة، وقال صلى الله عليه وسلم: ((أما الأولى، فإن الله فتح عليَّ بها اليمن، وأما الثانية فإن الله فتح عليَّ بها الشام والمغرب، وأما الثالثة فإن الله فتح عليَّ بها المشرق)).
أقول: أي أمل أعظمُ من هذا الأمل؟! لقد كان الصحابةُ في هذا اليوم – كما تُصوِّرهم الآية الكريمة: ﴿ إِذْ جَاؤُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا * هُنَالِكَ ابْتُلِي الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالاً شَدِيدًا ﴾ [الأحزاب: 10، 11].
وكذلك كان أصحابُه الكرام في الصبر والثبات على الدِّين أيام الغُربة الأولى.
ومن المعروف صبر آل ياسر، فقد ذكر ابن حجر في “الإصابة”: أن ياسرًا حالف أبا حذيفة بن المُغيرة، فزوجه أمَةً له يُقال لها: سُمية، فولدت عمارًا، ثم كان عمار وأبوه ممن سبق إلى الإسلام. فأخرج أبو أحمد الحاكم: أنَّ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – مرَّ بياسر وعمار وأم عمار وهم يؤذَوْن في الله، فقال لهم: ((صبرًا يا آلَ ياسر، صبرًا يا آلَ ياسر، فإنَّ موعدَكم الجنة)).
إن الصبر ضياء يُضيء جوانبَ النفس بالأمل المشرق، والنظرة إلى المستقبل بوجه يبسِمُ للمصاعب والمصائب، وهو ثمرةُ الإيمان الصادِق، وهو دليلٌ على العقل الراجح، ويدل على أن من يتَّصف به إنسانٌ مَلَكَ الرجولةَ التامَّة والشجاعة والقوة؛ لأنَّ الرجلَ الشديد هو الذي يملك نفسه في الأزَمات.
قال الشاعر:
وإذا رَمَتكَ الحادِثاتُ عَبُوسَةً
بِنِبالِها فاضْحَك لَها مُتَهَكِّما ما في بُكائِكَ إِنْ أُصِبْتَ بُطُولَةٌ
إِنَّ البُطُولَةَ أَنْ تُصابَ وتَبْسِما
وتقوى الله هي المنجاة في العُسر واليُسر؛ يقول تعالى: ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴾ [الطلاق: 2، 3].
والعاقبةُ للتقوى، كم قرأنا أخبارَ طغاة سقطوا! وكم سمعنا أخبارَ جبابرة هلكوا بعد أن ظلموا ونكلوا بالمؤمنين! ﴿ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴾ [البروج: 8]، ونجَّى الله بفضله الذين اتقوا ربَّهم، وكانت عاقبة أمرهم نصرًا وسيادة، وعزًّا ومجدًا.
إن الغربة قد تحدُث، ولكن يبقى الإسلامُ في يقيننا هو الدِّينَ الحقَّ؛ قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ﴾ [آل عمران: 19]، فمهما عظُمَت غربة هذا الدِّين فهو الدين عند الله، ونحن مأمورون باتِّباعه مهما كانت الظروفُ التي تحيط بنا؛ قال الله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ [آل عمران: 85]، والمتمسِّك بالإسلام في حال غربته هو أسعدُ الناس كما جاء في الحديث؛ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((فطوبَى للغُرَباء)).
نعم، يكون سعيدًا في الدنيا، ولَسعادَتُه في الآخرة أعظمُ وأكبر، قال الإمام النووي: “فرُوي عن ابن عباس – رضي الله عنه – أن معناه: فرحٌ وقرَّةُ عين، وقال الضحَّاك: غِبطةٌ لهم، وقال قَتادة: حُسنى لهم، وعن قتادة أيضًا: معناه: أصابوا خيرًا”.
وأعداء الإسلام عندما يرَون المسلم في حالة الغربة متمسكًا بالإسلام، متحدِّيًا كل هذه العوائق التي تقوم من حوله، يعظُم في أعينهم وفي قرارة نفوسهم، وإن كانوا – بعامل الحقد – يصوِّبون إليه سهامَ العدوان.
وإن المسلمَ الغريب ليجد لذَّةً فيما يلقى من العدوان، إن عثمان بن مظعون لمَّا ردَّ جوار الوليد بن المغيرة تعرَّض للأذى، فلطم رجلٌ عينَه فخضرها، فلما رآه الوليد قال له: أما والله يا ابن أخي، إن كانت عينُك عما أصابها لغنيَّة، لقد كنتَ في ذمَّة منيعة، فقال له عثمان: بل والله إن عيني الصحيحةَ لفقيرةٌ إلى مثل ما أصاب أُختَها في الله، وإني لَفي جوار مَن هو أعزُّ منك وأقدر.
وإنَّنا لنقرأ في كتاب الله أن السَّحَرة لمَّا آمنوا وهدَّدهم فرعون بأن يقطع أيديَهم وأرجلَهم من خِلاف، ويصلبَهم في جذوع النخل، لم يبالوا بتهديده ووعيده؛ بل ﴿ قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ﴾ [الشعراء: 50]، و﴿ قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴾ [طه: 72].
قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة:
“وكثير من الناس إذا رأى المنكرَ أو تغيَّر كثير من أحوال الإسلام، جزع وناح كما ينوح أهلُ المصائب، وهو منهيٌّ عن هذا؛ بل هو مأمورٌ بالصبر والتوكُّل والثبات على دين الإسلام، وأن يؤمنَ بأن الله مع الذين اتَّقوا والذين هم مُحسنون، وأن ما يصيبه فهو بذنوبه، فليَصْبر، إن وعد الله حق، وليستغفر لذنبه، وليسبح بحمد ربه بالعشِيِّ والإبكار”.
هذا، والغربة قد تكون في بلد دون بلد، فالمسلمون اليومَ في فلسطين الذين هم تحت حكم اليهود، يشعُرون بغربة الإسلام، وكذلك فقد كان المسلمون في فلسطين أيام حكم الصليبيين يحسُّون بغربة الإسلام، ثم زالت هذه الغربةُ ورجعت البلادُ لأهلها.
ليست الغربة لازمةً ولا لاصقة بهذا الدين؛ يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ((إنَّ الله يبعثُ لهذه الأمة على رأس كلِّ مئة سنة مَن يُجَدِّد لها دينها)).
ألا فليطمئنَّ الغُرباء، إن المستقبل للإسلام إذا هم استمسكوا بأحكام الإسلام، فوَعدُ الله حقٌّ لا يتخلَّف؛ يقول الله تعالى: ﴿ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ ﴾ [غافر: 51]، ويقول تبارك وتعالى: ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ [النور: 55].
وصلى الله على سيِّدنا محمَّد بن عبدالله، وعلى آله وصحبه وسلَّم.
والحمد لله ربِّ العالمين.
ـــــــــــــــــ
رواه أحمد 1/398، ومسلم برقم 145، والترمذي برقم 2629، وابن ماجه برقم 3986 و3987 و3988، والدارمي 2/311.
“سيرة ابن هشام” 2/87، و”مسند أحمد” 1/201 – 203، وانظر: “سيرة ابن إسحاق”؛ تحقيق د. محمد حميدالله ص 194، وانظر: “البداية والنهاية” لابن كثير 3/2، وانظر شرحنا للحديث في كتابنا: “من هدي النبوة” ص 372 وما بعدها.
“صحيح البخاري”، برقم 2934.
“سيرة ابن هشام” 1/375.
“سيرة ابن هشام” 1/379.
“سيرة ابن هشام” 2/14.
“سيرة ابن هشام”، 3/230.
“الإصابة”، 3/610.
“شرح مسلم” 2/176.
“سيرة ابن هشام” 2/ 9 – 10.
“مجموع الفتاوى” 18/295.
رواه أبو داود برقم 4291، وانظر كلام ابن كثير في “البداية والنهاية” 6/256، ولكاتب هذه السطور رسالةٌ في معنى الحديث ما تزال مخطوطة، وانظر كلام السُّبكي في “الطبقات الكبرى”.
طوبى للغرباء –
الدكتور محمد بن لطفي الصباغ
منقول للأمانة =)
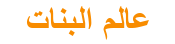 عالم البنات النسائي كل ما يخص المرأة العربية من ازياء وجمال والحياة الزوجية والمطبخ
عالم البنات النسائي كل ما يخص المرأة العربية من ازياء وجمال والحياة الزوجية والمطبخ